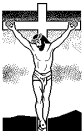|
في المقال السابق (عدد أكتوبر 2003، ص 10) تحدَّثنا عن تدبير التجسُّد وكيف أنه يتضمن - بحسب تعليم آباء الكنيسة - تدبير الخلاص من كِلاَ: خطية العصيان، كما من نتائج هذه الخطية. ثم تحدَّثنا عن الصليب في تعليم الآباء وكيف أن خطايانا سُمِّرت مع المسيح على الخشبة. كما تكلَّمنا عن المسيح باعتباره هو الذبيحة وهو الكاهن مقدِّم الذبيحة بآنٍ واحد، ولذلك فإن ذبيحة المسيح هي ذبيحة كاملة. ونُكمل في هذا المقال حديثنا عن الصليب ومكانة موت المسيح في التدبير الإلهي للخلاص. الفرق بين احتياج البشر للخلاص، واحتياج الله ليُخلِّص البشر: شتَّان مــا بين احتياج الإنسان ليخلُص، وبين احتياج الله أن يعمل بطريقــة معينة ليُكمِّل خــلاص البشر. يُصوِّر آباء الكنيسة الشرقية (وآباء كنيسة الإسكندرية على وجه الخصوص)، تدبير الله للخلاص على أنه عمل شفائي "ضروري" لمرض البشرية العام. فالبشرية بسبب السقوط وعدم تأثير الناموس والأنبياء في علاج هذا السقوط، احتاجت إلى دواء أقوى. لذلك فقد صار "ضرورياً" للإنسان - ما دام لابد للإنسان كله جسداً ونفساً أن يخلص - أن يكون المخلَّص إلهاً كاملاً وإنساناً كاملاً. وكان لابد أن تكون ذبيحة الجلجثة ضرورة من أجل خلاص البشر. لكن كل هذه "الضرورات" لم تكن تلقي حتمية على الله، ولكن ذلك تم عن ضرورة "تدبيرية" كما يُسميها الآباء، أي أن ما دبَّره الله ليُخلِّص البشر كان وسيلة ضرورية للبشر، ولكن ليس حتمية على الله. فنحن "الذين احتجنا إلى تجسُّد إلهي، وإلى إله يموت لكي نحيا". ولكن دون حتمية منطقية أو قضائية تُفْرَض على الله ليعمل ما عمله في خلاصنا. وكما قال أحد اللاهوتيين الأرثوذكس: "الصليب كان ضرورة للطبيعة البشرية، وليس لإرضاء العدل الإلهي." ويقول القديس غريغوريوس اللاهوتي إن الله كان يمكنه أن يختار طُرقاً أخرى لخلاصنا، فقد كان يمكنه مثلاً أن يُخلِّصنا بفعل إرادي فقط. ولكن ما فعله الله كان الدافع إليه هو ما نُردِّده في قانون الإيمان: "من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا"، وليس كما تحتَّم على الله أن يعمله، أو كما يتصوَّر البعض أنه يتحتَّم عليه أن يعمله. الصليب "الدواء اللطيف" لمرض البشرية: وهكذا لا تعود الآلام وموت الصليب باعتبارهما قمة التجسُّد تقودنا أن نرى في الصليب دواءً "عنيفاً" لشفاء حالة البشرية الساقطة. حقًّا كـان التجسُّد "انقلاباً على ناموس الطبيعة البشرية"، إلاَّ أن الآبـاء القديسين يـرفضون أن يَرَوْا في تـدبير الله إلاَّ الرحمة واللطف وطـول الأناة في الخالق المحب الذي لا يشاء أن يرى خليقته تهلك. لأنه لو كان الله قد استخدم وسائط "عنيفة" لفعل الخلاص، فما كان يمكن أن تؤدِّي في ظل كبرياء البشرية إلاَّ إلى ازدياد عصياننا. ولكن "الواسطة اللطيفة الحنونة للشفاء" هي التي أمكنها أن تقنعنا وتردَّنا عن عبادة الأوثان. ويزيد القديس غريغوريوس الشرح فيقول إن البشرية مثل غصنٍ جاف منثنٍ كان يمكن أن ينكسر إذا أُجبر بالقوة وفجأة على الرجوع إلى وضعه الطبيعي. فالبشرية بتصويرها كغصنٍ منثنٍ كانت في حاجة إلى دواء "غير عنيف" ليُعطينا رؤية جديدة - بحسب فهم القديس غريغوريوس - لمكانة موت المسيح في التدبير الإلهي للخلاص. وهذه الرؤية لها جانبان: الأول: إن الدواء قد أُعطِيَ من خلال ذبيحة ابن الله المتجسِّد؛ والثاني: إن الشفاء لا يتم حالاً ولا آلياً. وهذان الجانبان سنفحصهما الآن. الجانب الأول: سرُّ ذبيحة المسيح وكيف اكتملت في القيامة: لا يمكن أن ننكر أن المعلمين القديسين كانوا يفهمون الخلاص على أنه اكتمل على الصليب أولاً. فالصليب هو قمة عمل الله في نزوله ليرفع الخليقة الساقطة. فباتخاذ الله الطبيعة البشرية والحياة البشرية والموت البشري، بطلت نتائج السقوط. الصليب هو إعلان الانتصار على الخطية والموت، فهو الذي حررنا من البؤس والذُّلّ. لقد هُزمت الخطية وبَطُلَ الموت، وقوة الشيطان قد تحطَّمت. وحينما يتحدث آباء الكنيسة المعلِّمون عن القيامة، فهم لا يصفونها على أن "الانكسار" على الصليب قد تحوَّل بطريقة معجزية إلى "انتصار" في القيامة. فالقيامة لم تكن إعلاناً على أن المسيح مات ظلماً، والقيامة هي ردُّ هذا الظلم؛ بل إن القيامة تبعت الصليب لأن الله هو الذي كان مصلوباً. إن المسيح المصلوب صار موضوع تسبيح وتمجيد في الكنيسة: "لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد. آمين". فـالقيامـة هـي، إذن، استمرارٌ لـ "قوة التجسُّـد". وربما لـو قـرأنــا العظتين اللتين ألقاهمـا القديس غريغوريـوس اللاهوتي، لعجبنا أنــه يتكلَّم عــن القيامة بـأقل مما يتكلَّم عـن الصليب، وهـذا عنده أمرٌ طبيعي. فالقيامة هي ارتفاع يُشير إلى تكميل النزول. فالله نزل لكي يرتفع. والبشرية يمكنها أن تشترك في قيامـــة المسيح بسبب اتخـاذ المسيح لنفسه الطبيعة البشريــة كلهـا بحياتهـا البشريــة وموتهـا البشري. فنحن نُشارِك في الانتصار الذي أكمله وأتمَّه الابن الذي تجسَّدنا؛ وآدم العتيق قد أُبيد، والبشرية تقوم مع المسيح في خليقة جديدة. وإن سرَّ "الله صار إنساناً في المسيح" يُستعلن أساساً في صَلْبه الذي صار هو مَجْدنا، وفي موته الذي صار هو حياتنا، وفي دفنه في القبر الذي صار هو قيامتنا. ثم يكتمل معنى هذا السر: "الله صار إنساناً" في الغاية النهائية لهذا السر: "ليصير الإنسان إلهاً." وهكذا، وبواسطة تدبير التجسُّد، تمَّ الخلاص، ودواء مرض البشرية العام أُعطي. وهكذا تقدَّست البشريـة التي سقطت، ببشريـة ابـن الله؛ أي "بقوة التجسُّد". إذ دخل الابـن المتجسِّد في عمق أعماق حالة بشريتنا التي سقطت وصار مثل "خميرة" تُدفن في عمق "عَجْنة البشرية". وهكذا تطهَّر العالم، واستُردَّت صورة الله، وكل الخليقة اجتمعت والتأمت مرة أخرى تحت أُبوَّة الله. الجانب الثاني: الجهاد والنمو نحو اقتناء كمال الخلاص: ثم نأتي إلى الجانب الثاني حيث نعود إلى تشبيه الغصن المنثني الذي استرد استقامته مرة أخرى، هل صار المنثني مستقيماً حتى ولو كان الدواء الموصوف لطيفاً وليس عنيفاً مُهلكاً؟ تعطي كتابات آباء الكنيسة دليلاً قوياً على إجابتهم على هذا السؤال. فالدواء قد أُعطِيَ، ولكن الشفاء آخذٌ في الاكتمال. فالخلاص لا يمكن أن يتم لحظياً أو آلياً. ففي نصَّين متشابهين، يستعرض القديس غريغوريوس أمام شعبه أحداث التجسُّد من حياة وموت المسيح، ثم يعود إلى "ألقاب" الابن كما عرفناها؛ فيقول إنكم إذا كنتم تتشبَّهون بألقاب المسيح، فإنكم يمكن أن تصيرواً "إلهاً" بارتفاعكم من الحضيض تماماً كما أن المسيح صار من أجلنا إنساناً بنزوله من أعلى سمائه. وإن نحن ارتحلنا من خلال كل مرحلة من مراحل حياة المسيح، فسوف نقوم معه، ونتمجَّد معه، ونملك معه. وفي كل هذه المراحل، لا يكون الخلاص حدثاً قد اكتمل في حياتنا نحن. لقد اكتمل الخلاص على الصليب وفي القيامة والصعود كأساس. وتدبير تجسُّد الابن هو بداية خلاصنا، وهو الأساس الذي عليه يرتكز الخلاص. الخلاص قد أُنجز، ولابد أن يُمارسه المؤمن من أجل نموه، هذا النمو الذي هو موهبة فعَّالة للبشرية. هذا "الدواء اللطيف" أُعطِيَ للبشرية لكي تقتنع به. والخلاص في تطبيقه العملي ليس آليًّا ولا آنيًّا، بل هو نمو فعَّال دائم الحركة والتقدُّم. وهكذا تكون غاية التجسُّد التي هي "الثيئوسيس" عملية نمو وتقدُّم نحو فهم مقاصد الله، ونحو الشركــة في الطبيعة الإلهيــة. وكـذلك فـإن فَهْمَنا للمسيح لا يجب أن يكـون مجـرد فهم جامد لكيفية اتحاد الطبيعتين في المسيح، بل إدراك القصد الفعَّال للتجسُّد، حيث نراه ليس فقط في اتخاذ ابن الله الطبيعة البشرية، بل وأيضاً اتخاذه لعموم الحياة البشرية والموت البشري. إن الخلاص قد تمَّ لكل الجنس البشري، إلاَّ أن هذا "الخلاص" ليس سوى بداية. فإذ قد خلصنا، فنحن مدعوُّون إلى دعوة عُليا؛ وإذ قد خلصنا، فنحن ما زلنا نملك زمام إرادتنا الحُرَّة. فخلاصنا لا يمكن أن يكون رغماً عن ملء إرادتنا. فـ "الدواء الخفيف" يجعلنا نقتنع، وليس بــأن ينكسر غصننا (كمـا في تشبيه الغصن المنثني). وبنـــاءً على هذا، فلابد أن نختار الخلاص الذي أتمَّه لنا ابن الله المتجسِّد، وكما "قَبـِلَ" الآب الدمَ المحيي والغافر الذي سفكه ابنه الوحيد؛ هكذا على المؤمن المسيحي أن "يقبل" بإرادته بركات هذه الهبة الإلهية الثمينة. وبمقتضى تدبير التجسُّد، تكون البشرية مدعوَّة لأن تتحرك نحو الله، ردًّا على تحرُّك الله أولاً نحوها، وهي واثقة من اتجاهها ومن ضمان بلوغها الغاية المرسومة. نحـن نعيش في عـالمٍ متغيِّر وجديد. وبالرغم مـن التغيُّر السريع للعالم، إلاَّ أن ما يحيطنا من مظاهر الخليقة الساقطة، لن يكون عائقاً أمامنا لتقدُّمنا نحو غاية التجسُّد. إن "الثيئوسيس - الشركة في الطبيعة الإلهية" الذي كان مصيرنا المرسوم لنا قبل السقوط، أصبح الآن مصيرنا المتجدِّد الممنوح لنا مرة أخرى. يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي إن قيامة المسيح وصعوده قد أكملا سلسلة الأحداث الخلاصية التي بها عمل الله خلاصنا في المسيح يسوع. فإن كان "المسيح حسب الجسد" أي الذي عاش 33 سنة على الأرض لم نَعُد نعرفه حسب الجسد كما قال بولس الرسول: "إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد" (2كو 5: 16)، أي أن ميلاده ومحاكمته وموته وقبره وقيامته ثم صعوده إلى السموات قد انقضى؛ إلاَّ أن المسيح "الرب الروح" هو ممجَّد الآن بأكثر مجد، لأنه صار لنا تحقيق "الموعد" وعربون "رجائنا"، وأصبح "جسد المسيح" الآن ليس جسداً "حسب الجسد" بل حسب "تدبير الروح الذي ابتدأ وما زال يُكمَّل." (يتبع) |