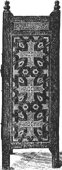|
|
|
|
فصل إنجيل قدَّاس الأحد الرابع من شهر بؤونة يأتي في الأيام الأخيرة من صوم الرسل(1) الذي يُختم بعيد استشهاد الرسولَيْن بطرس وبولس في 5 أبيب (12 يوليو).
وهذا الفصل هو جزء من الموعظة على الجبل التي أوردها القديس متى كخطاب متصل في أصحاحات ثلاثة متتالية من بشارته (7،6،5)، ولكن القديس لوقا يذكرها مُجزَّأة بترتيب مختلف وبنصٍّ لا يتطابق تماماً ضمن الأصحاحات السادس والحادي عشر إلى الرابع عشر.
والآيات المختارة في هذا الفصل من الإنجيل تدور حول وصية محبة الأعداء التي قدَّمت مفهوماً مُغايراً تماماً لِمَا ساد حياة البشر قبل مجيء المسيح(2).
وإذا عُدنا إلى ما قبل ”الوصايا العشر“، فقد عاش الناس قروناً تحت إرشاد ناموس طبيعي قد أودعه الله فيهم هو الضمير. ولكن الطبع الشرير للإنسان (تك 8: 21) كان أقوى من ضميره، وهو لم يمنعه من القتل (قايين وموسى)، والحقد والانتقام (عيسو)، والحسد والكذب (إخوة يوسف)، وسائر القائمة المظلمة للضعف الإنساني.
على أنه بناموس العهد القديم – الذي أحدث نقلة نوعية في حياة البشر – وُهب الإنسان دستوراً قوامه العدل يؤازر عمل الضمير الذي لم يَكْفِ وحده لقهر الكبرياء والأنانية والمحاباة والميل إلى الشر. ولتحقيق العدل كانت عقوبة المعتدي رادعاً عن البدء بالتجاوز، كما أنها أتاحت القصاص: فالعين بالعين والسن بالسنِّ (خر 21: 24؛ مت 5: 38). ولكن الناموس، وإن حقَّق العدل، إلاَّ أنه لم يستأصل العداوة، ولم يَشفِ الإنسان من شرِّه.
على أيِّ حال، ولفترة امتدَّت خمسة عشر قرناً، كان الناموس خطوة للأمام ووسيلة لضبط العلاقات بين البشر بقوة القانون، وهو قد هيَّأ الإنسان للرحلة الأخيرة حين استُعلِن ناموس المسيح وعهد الله الجديد (إر 31: 31-34؛ عب 8: 10-12) الذي حمل في ثناياه قوة النعمة والحق (يو 1: 17) وعمل الخلاص بالدم، وهو الذي بالإيمان يلد الإنسان ثانية (1بط 1: 23) من الماء والروح (يو 3: 5)، فيخلقه جديداً في المسيح يسوع (2كو 5: 17)، ويُصيِّره ابناً لله (1يو 3: 1).
وناموس المسيح أكمل الناموس القديم (مت 5: 17) بالانتقال إلى شريعة المحبة، واتسع معنى ”القريب“ في الوصية: من الدائرة الضيقة (الأقرباء بالجسد أو الشركاء في الديـن أو الوطن أو الجماعة أو الحزب) ليضمَّ كل البشر ولا يستبعد منهم أحــداً حتى العدو (لا 19: 18؛ مـت 19: 19؛ 22: 39؛ مـر 12: 31؛ لـو 10: 25-37؛ رو 13: 9؛ غل 5: 14؛ يع 2: 8).
والمسيح ابن الله الظاهر في الجسد، قدَّم وصايا جديدة غير مسبوقة. وهي لم تكن وهْماً جميلاً أو كلاماً سامياً مكانه متاحف التاريخ، وإنما قالها ومعها قوة تنفيذها لأنَّ إمكانيات الإنسان الذاتية تقصر عن استيعابها فضلاً عن ممارستها. فالمسيح يحيا فينا (غل 2: 20)، وهو الذي يحوِّل كلمته فينا إلى حياة وسلوك كنعمة مجانية.
? «أحبُّوا أعداءكم»:
هذه الوصية تحتوي كل ما يليها. فالعداء والبغضة يفرزان اللعنة والإساءة والعدوان بكل صوره.
? والمسيح عندما أَخَذَ جسد الإنسان، جعل من نفسه القدوة والمثال للإنسان الجديد في مسيرته، حسب الإنجيل: «تاركاً لنا مثالاً، لكي تتَّبعوا خطواته» (1بط 2: 21)، وهو الذي قال: «تعلَّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت 11: 29).
والرب هو الذي بيَّن محبته لنا بأنْ «وضع نفسه لأجلنا» (1يو 3: 16) «ونحن بعد خطاة»، كما أننا «ونحن أعداء قد صولحنا مع الله (الآب) بموت ابنه (يسوع المسيح)» (رو 5: 10،8). والكتاب يُخاطبنا: «أنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين وأعداء في الفكر، في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليُحضركم قدِّيسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه» (كو 1: 22،21).
نعم «كُنَّا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً» (أف 2: 3). والمسيح أحب «إلى المنتهى» (يو 13: 1) مَن صاروا أحبَّاءه ومَن عادوه وصلبوه وسأل الغفران لهم «وهو مات لأجل الجميع» (2كو 5: 15).
? إذاً، ففيما نجاهد لطاعة الوصية، فنحن نُثبِّت عيوننا على شخص الرب ونسير على هَدْي خطواته. وكما صار يسوع شبيهاً بنا بالجسد (رو 8: 3؛ في 2: 7؛ عب 2: 17)، فقد وهبنا الآب بالنعمة أن نكون نحن أيضاً مُشابهين صورة ابنه في بهائها «ليكون هو بِكْراً بين إخوة كثيرين» (رو 8: 29). وفي المسيح نحن نسلك في كل فضيلة (2بط 1: 5)، ونعيش بالتقوى (2تي 3: 12)، ونتألَّم معه لكي في النهايـة نتمجَّد معه (رو 8: 17؛ 2كو 4: 17)، و«نكون مثله» (1يو 3: 2)، ونستوطـن عنده في ملكوتـه (2كو 5: 8).
? وارتباط وصية ”محبة القريب“ بالوصية الأولى والعُظمى (مت 22: 38)، التي هي محبة الله من كل القلب والنفس والفكر والقدرة، والتي تُقدِّس المؤمن؛ فهي مِن ثمَّ تُهيِّئه لمحبة الآخر تلقائياً، لا لحساب الذات، وإنما لحساب الله الذي نقله من الظلمة إلى النور. هكذا تصير المحبة فعلاً إرادياً بغير جهد أو افتعال ولكن بكل رضًى وبغير تراجُع، حتى أنه يصير طبيعياً أن يُطالبنا القديس بطرس أن تكون محبتنا «من قلب طاهر بشدَّة» (1بط 1: 22).
? والمسيح في دعوته لمحبة الأعداء يكشف عن قوة المحبة وأنها قادرة على غلبة الكراهية، بل وسَحْق الخطية والموت. ومكتوب عنها: «المحبة قوية كالموت... مياه كثيرة لا تستطيع أن تُطفئ المحبة» (نش 8: 7،6).
الكراهية سلبية: هي مجرد الاستجابة لعُقَد الخوف والضعف ورَفْض الآخر والخضوع لأدنى النوازع في أغوار النفس المظلمة المتغرِّبة عن الله، وهي تـأكل صاحبها كما يُذيب الحامض الإناء الذي يحتويه. ومُعلِّمنا يـوحنا يُقْرِن البغضة بالظلمة والموت وقتل النفس (1يو 1: 11،9؛ 3: 15،14).
ولكن المحبة إيجابية: تُعطي وتبذل حتى الموت، تعفو وتُسامح وتغفر. وهي «... تتأنَّى وتَرْفُـق. المحبة لا تحسد. المحبة لا تتفاخر، ولا تنتفخ، ولا تُقَبِّح، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتدُّ، ولا تظُـنُّ السوء، ولا تفـرح بـالإثم بـل تفرح بالحق. وتحتمل كل شيء، وتُصدِّق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء»، وهي تظل قائمة صامدة منتصرة و«لا تسقط أبداً» (1كو 13: 4-8). والقديس يـوحنا يُقرنها بالنور والحياة الأبدية (1يو 1: 10؛ 3: 14).
? محبة الأعداء علامة شاهدة على صدق الإيمان والحياة في المسيح وطاعة الوصية ومؤازرة النعمة، وهي وسيلتنا التي لا تخيب لغلبة البغضة ودحرها.
مقابلة العداء بالعداء تُشعل الكراهية وتزيدها لهيباً، والكل يدورون في حلقة مُفرغة لا تنتهي، وجميعهم ضحايا خاسرون. دخول ”المحبة في هذا الأَتون“ كإلقاء الماء على النار فتنطفئ والكل رابحون، فقد تمَّ إنقاذ العدو من نفسه، والمُحِب ربح انتصار محبته ونجاته هو أيضاً من السقوط في البُغضة، فربح نفسه: «لا يغلبنَّك الشر، بل اغلب الشر بالخير» (رو 12: 21).
? «أَحسِنوا إلى مُبغضيكم»:
هذا تفصيل للوصية السابقة. فنحن «لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق» (1يو 3: 18). فلا يكفي ألاَّ نُقابل البغضة بالبغضة. فالإيجابية المسيحية تقتضي مِمَّن غيَّرته نعمة الله أن يُقابل البغضة الصامتة أو الفاعلة بالإحسان من رصيد لا ينفد أبداً في قلب تابعي المسيح، سواء بالكلمة أو العمل الطيِّب، خاصة إذا كان العدو يجتاز ضيقة ما، فهنا الوقت المُحتَّم لا للتشفِّي، وإنما لتقديم المعونة المُخْلِصة واستعلان المحبة التي يمكن أن توقِظ النوازع الطيبة التي طمرتها الكراهية في الأعماق.
? الإحسان وحده هو نوع ”الانتقام“ المسموح لنا به إزاء مَن يُبغضنا: «إنْ جاع عدوُّك فأَطْعِمْهُ. وإنْ عَطِشَ فاسْقِهِ» (أم 25: 21؛ رو 12: 20). الانتقام الرادع لا يصح أن يشغلني، فهو ليس مهمتي ويتجاوز دوري في الحياة، لأنه عمل الله واختصاصه: «لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحبَّاء، بل أَعطوا مكاناً للغضب (أي غضب الله وأيضاً حكمته وعدله ورحمته)، لأنه مكتوب: ”لي النقمة أنا أُجازي يقول الربُّ“» (تث 32: 35؛ رو 12: 19).
? «باركوا لاعنيكم،
وصلُّوا لأجل الذين يُسيئون إليكم»:
الكراهية هنا ليست مجرد مشاعر سلبية كالمقاطعة أو إشاحة الوجه أو عدم التحية والسلام، وإنما هي المبادرة بالإساءة بالكلام أو العمل المضاد. والقديس بولس يذكر الوصية هكذا: «باركوا على الذين يضطهدونكم. باركوا ولا تلعنوا» (رو 12: 14).
? اللعنة تكون بالكلام، والرد عليها يكون بطلب البركة؛ والإساءة يمكن أن تكون بالكلام أو الأفعال التي تُعبِّر عن الإهانة أو الاحتقار، والرد هو الصلاة من أجل المُسيء. والصلاة من أجل المُسيء، كطلب البركة، هدفها تغيير اتجاه قلبه وفكره وإيقاف تيار عدائه باستدعاء الروح للتدخُّل كي يراجع نفسه ويثوب إلى رشده، أو ربما اهتدى إلى الحق وتتم المصالحة.
? فإذا كانت الإساءة اعتداءً بدنيّاً بأيِّ نوع («مَن ضربك على خدِّك») فلا سماح للردِّ بمثله، لأن النتيجة هي اتساع دائرة العنف مما يُعطي المعتدي مُبرِّراً يجعله راضياً عن فعله. أما الاحتمال وعَرض الخد الآخر، فإنه يحرم المعتدي من تبرير اعتدائه، وربما يخجله فينفتح باب للمصالحة.
ورغم صعوبة مثل هذه المواقف وصعوبة الوصية التي تتطلَّب نفوساً يحيا المسيح فيها فعلاً، وترى في طاعة الوصية أمراً مقضياً به، فإنَّ المسيح شريكنا في الضيقة قد سبق وجاز هذا الاختبار من أجلنا: «والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغَطَّوْه وكانوا يضربون وجهه» (لو 22: 64،63)، «ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدم» (يو 18: 22)، حتى إذا حملنا نيره علينا يكون هَيِّناً وحِمْله خفيفاً (مت 11: 30،29).
وإذا كانت الإساءة خطفاً أو سرقة، فالرب هنا يوصي بالتنازل والقبول، فربما تجلب المقاومة ضرراً أشد(3).
? محبة الأعداء هي الفارق:
يواصل الرب خطابه للمؤمنين ليكشف عن ماهية المحبة الحقيقية. إنها ليست محبة الوالدين الغريزية لأولادهما، فهذه محبة ومسئولية أودعها الله فيهما لرعاية الصغار إلى أن يشبُّوا عن الطوق (وهي ليست قاصرة على الإنسان، ولكنها أيضاً في الحيوانات الأليفة والمتوحشة على السواء). كما أنها ليست أن نحب من يحبوننا من الأقارب(4) والأصدقاء، فهذا اللون من المحبة لا فضل لأحد فيه: «وإنْ أحببتم الذين يُحبُّونكم، فأيُّ فضل لكم؟ فإنَّ الخطاة أيضاً يُحبُّون الذين يُحبُّونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يُحسنون إليكم، فأيُّ فضل لكم؟ فإنَّ الخطاة أيضاً يفعلون هكذا» (لو 6: 33،32).
? المسيح لا يعوِّل كثيراً على المعاملات المتكافئة المتبادَلة ولا يرى فيها تمييزاً لطرف على الآخر: «وإنْ أقرضتم الذين ترجون أن تستردُّوا منهم، فأيُّ فضل لكم؟ فإنَّ الخطاة أيضاً يُقرضون الخطاة لكي يستردُّوا منهم المِثْل» (لو 6: 34).
? المسيح يدعو إلى أن نُعطي ولا ننتظر أن نأخذ شيئاً إلاَّ من الله الغني: «أَعطوا تُعْطَوْا، كيلاً جيِّداً مُلبَّداً مهزوزاً فائضاً يُعْطُون في أحضانكم» (لو 6: 38). من هنا تستمد محبة الأعداء قيمتها. فهي محبة تُعطي ولا تأخذ، وهي المحبة التي تنفرد بها المسيحية وحدها، وهدفها إنقاذ العدو من بغضته، وفي ممارستها نحن نقتدي بصاحب الوصية الذي بذل حياته من أجل أعدائه. والرب جعل تنفيذنا لهذه الوصايا الشهادة أننا أبناء الله: «بل أحبُّوا أعداءكم، وأَحسِنوا وأقرضوا وأنتم لا تَرجُون شيئاً، فيكون أجركم عظيماً وتكونوا بني العَليِّ» (لو 6: 35).
خلاصة القول، أنه لكي نُنفِّذ وصايا المسيح بما فيها «أحبُّوا أعداءكم»، فيجب أن نكون مسيحيين بالروح والحق.
دكتور جميل نجيب سليمان
(1) ومدته هذه السنة 18 يوماً فقط (بسبب الموعد المتأخِّر لعيد القيامة). ولكن صوم الرسل يمكن أن يمتدَّ ليبلغ 49 يوماً، إذا بدأ الصوم الكبير مُبكِّراً تبعاً لتغيُّر موعد عيد القيامة (الذي يجب أن يلي عيد الفصح اليهودي) بين 26 برمهات (4 أبريل) إلى 30 برمودة (8 مايو).
(2) اختيار فصل هذا الإنجيل خلال صوم الرسل، الذي هو صوم الكرازة والخدمة، يبدو مناسباً تماماً. فالعمل الكرازي لم يكن يـوماً بين أصدقاء موالين، وإنما في أكثر =
= الأحيان بين مقاومين ومعادين، وفي أفضل الأحوال بين محايدين أو غير مبالين. فالخادم أو المؤمن الكارز يدخل إلى قلب المخدومين بهذا الشعار: «أحبُّوا أعداءكم»، حيث تغلب محبته العداء والبُغضة واللعنة والإساءة. وهكذا إذ يؤمنون ينالون القوة التي يتحوَّلون بها إلى محبة أعدائهم هم أيضاً، وهكذا. (3) على أن اللجوء إلى القانون في الدولة الحديثة لا يُعتبر تجاوزاً للوصية، والكتاب يُشير أنَّ «السلاطين الكائنة هي مُرتَّبة من الله»، وأن الحاكم «هو خادم الله، مُنتقم للغضب من الذي يفعل الشر» (رو 13: 4،1). كما أن الخضوع في كل الأحوال للمعتدي والمُسيء وتركه يفلت من القانون، يُشجِّعه على الإمعان في انحرافه بما يعود بالضرر = = على الآخرين، وربما يقوده هو في النهاية إلى الهلاك. ولا شكَّ أن في عقوبة مَن يتجاوز القانون إنقاذاً له وإعادته إلى جادة الصواب. (4) ولكن حتى هذه المحبة في مجال العائلة ليست قانوناً. فالجرائم بين أفراد العائلة الواحدة تمتلئ بها صفحات الصحف، والرب أشار إلى أنه في بعض الأحيان يكون «أعداء الإنسان أهل بيته» (مي 7: 6؛ مت 10: 36) الذين يُقاومون قبوله الإيمان.