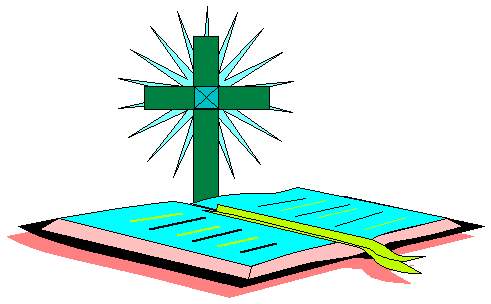|
دراسة الكتاب المقدس
|
|
|
(تابع) تفاصيل العهد وشروطه (12: 1 - 26: 19)
أولاً: الأحكام المتعلِّقة بالعبادة (12: 1-16: 13)
يتضمن هذا الأصحاح ثلاثة موضوعات متميزة، ولكن يربطها معاً خيط واحد، يتعلَّق بامتياز شعب الله عن جميع شعوب الأرض في كونهم محسوبين أولاداً للرب إلههم، وشعباً خاصاً مقدساً له، فيليق بهم أن يسلكوا سلوكاً يتفق مع دعوتهم الخاصة واختيارهم. وأول هذه المتطلبات هي:
أ – لا تتشبهوا بالوثنيين في تشويه أجسادهم حزناً على موتاهم:
لذلك يقول لهم موسى النبي:
+ «أنتم أولاد للرب إلهكم. لا تخمشوا أجسامكم، ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» (14: 2،1).
مما يلفت نظرنا هنا قول موسى لهم: «أنتم أولاد للرب إلهكم». فقد كان أول تلميح لهذه الصفة التي نعت بها الرب بني إسرائيل بأنهم ”أولاد للرب“، هو ما جاء في سفر الخروج، حينما قال الرب لموسى، عندما أرسله ليُخرج شعبه من أرض مصر: «تقول لفرعون، هكذا يقول الرب: إسرائيل ابني البكر. فقلتُ لك: أطلق ابني ليعبدني...» (خر 4: 22-23). ويُستشف من هذا القول إن دعوة الله لإسرائيل باعتباره ”ابنه البكر“، معناه أنه بكر بين إخوة كثيرين هم باقي شعوب الأرض كلها، وقد بدأ الله بدعوة إسرائيل كبكر لكي يسترِدَّ بواسطته ومن خلاله جميع أبنائه المتفرِّقين ويجمعهم إليه بشرط أن يسمعوا صوته ويحفظوا وصاياه، وإلاَّ فقدوا هم أيضاً هذه النعمة وهذا الاختيار والتبنِّي. والواقع أن تبنِّي الله للإنسان لم يأتِ من فراغ أو كأنه جاء اقتحاماً بلا تمهيد سابق؛ فالله الذي قال – منذ الأصحاح الأول لسفر التكوين - «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» (تك 1: 26)، نوى منذ البداية أن يتبنَّى الإنسان ويُورِّثه كل صفاته ويحتضنه بنعمته، ويجعله شريكاً له في قداسته وفي ملكوته وفي حياته الأبدية.
لذلك لما أراد الله أن يُعيد للإنسان صورته وبنوَّته التي فقدها بتعدِّي آدم، اختار شعب إسرائيل ودعاه ابنه البكر، لكي من خلاله يُرسل ابنه الحقيقي ليأخذ شكل العبد ويتجسَّد ويتأنَّس، لكي يُقدِّس طبيعتنا التي فسدت ويرفعها إليه، ويُعطينا ما له بعد أن أخذ الذي لنا.
وفي هذا يقول القديس كيرلس الكبير:
[لقد وضع الكلمة نفسه لكي يرفع إلى علوِّه أولئك الذين هم هابطون بالطبيعة. ولَبـِسَ شكل العبد مع أنه بالطبيعة هو الرب والابن، لكي ينقل مَن هو عبدٌ بالطبيعة إلى مجد البنوَّة على مثاله وبالصلة به...](1).
والواقع أن تبنِّي الله لإسرائيل كان إشارة إلى الابن الحقيقي الذي بواسطته سيكون كل الذين يقبلونه ويؤمنون به أبناء لله بالتبنِّي: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه» (يو 1: 12). كما يقول أيضاً بولس الرسول: «الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كُنَّا أولاداً، فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله ووارثون مع المسيح» (رو 8: 17،16). وأيضاً قوله: «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع» (غل 3: 26). هذه البنوَّة تقتضي منا أن نسلك كما يحق للدعوة التي دُعينا إليها، بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة (أف 4: 2،1). كما أنه يليق بنا أن لا نحزن من جهة الراقدين «كالباقين الذين لا رجاء لهم» (1تس 4: 13)، لأننا نؤمن أننا أولاد الله ووارثون مع المسيح للحياة الأبدية.
أما بالنسبة لبني إسرائيل، فقد شرح موسى لهم لماذا دعاهم الرب «أولاداً للرب إلههم»، قائلاً: «لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» (14: 3). وقد سبق الرب وأعلن لهم ذلك من قبل في نفس هذا الحديث، قائلاً: «لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إيَّاك اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» (تث 7: 6).
وبما أنهم أولادٌ للرب إلههم، وشعبه الخاص، فهو يوصيهم ألاَّ يتشبهوا بالوثنيين، فيخمشوا – أي يخدشوا أو يجرحوا – أجسادهم، ولا يجعلوا قرعة بين أعينهم – أي لا يحلقوا الشعر الذي بين حواجبهم – كعادة الشعوب الوثنية، كعلامة على حزنهم المفرط على موتاهم. فقد سبق أن أوصاهم الرب في سفر اللاويين ألاَّ يفعلوا ذلك في أجسادهم التي هي ملك للرب إلههم، لأنهم مقدَّسون للرب، إذ قال لهم: «لا تجرحوا أجسادكم لميت، وكتابة وسمٍ لا تجعلوا فيكم، أنا الرب» (لا 19: 28)، «وتكونون لي قدِّيسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميَّزتكم من الشعوب لتكونوا لي» (لا 20: 26).
فإن كان الأمر كذلك بالنسبة لبني إسرائيل فإنه بالأَوْلى جداً يكون بالنسبة لنا، إذ يقول في ذلك بولس الرسول: «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم. لأنكم قد اشتُريتم بثمنٍ، فمجِّدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله» (1كو 6: 20،19). إذن، فأجسادنا ليست ملكاً لنا حتى نفعل بها ما يحلو لنا، فهي أعضاء للمسيح: «ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء للمسيح؟! أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟! حاشا» (1كو 6: 15).
والواقع أن بعض الشعوب الوثنية، في سالف الزمان بل وحتى الآن، يظنُّون أن تجريح أجسادهم وتعذيبها إرضاءً لآلهتهم هو أمر لازم في طقوس عبادتهم، مثلما حدث في أيام إيليا النبي عندما طلب من أنبياء البعل أن يُقدِّموا ذبيحة لإلههم، كما يُقدِّم هو أيضاً للرب إلهه، والذي يستجيب له إلهه بنار من السماء تأكل ذبيحته فهو الإله الحي الذي يحقُّ عبادته واتباعه. فأخذ أنبياء البعل يرقصون حول مذبحهم، وكانوا يصرخون بصوتٍ عالٍ «وتَقطَّعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم... ولم يكن صوت ولا مُجيب ولا مُصغٍ»؛ أما إيليا فحينما تضرَّع إلى الرب إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل، استجاب له الرب وسقطت نار من السماء، «وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه» (انظر 1مل 18: 25-39).
ب – الامتناع عن أَكْل كل ما هو نجس من الحيوانات والأسماك والطيور:
هذا هو الطلب الثاني من الوصايا التي عليهم أن يُراعوها، أن لا يأكلوا رجساً ما: من البهائم والأسماك والطيور، لأنهم شعب مقدس للرب إلههم، كما سبق فقال لهم: «أنا الرب إلهكم الذي ميَّزكم من الشعوب، فتميِّزون بين البهائم الطاهرة والنجسة وبين الطيور النجسة والطاهرة. فلا تُدنِّسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكلِّ ما يدبُّ على الأرض مما ميَّزته لكم ليكون نجساً. وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب. وقد ميَّزتكم من الشعوب لتكونوا لي» (لا 20: 24-26). وهو هنا يؤكِّد هذا المطلب قائلاً:
+ «لا تأكل رجساً ما. هذه هي البهائم التي تأكلونها: البقر والضأن والماعز، والأُيَّل (هو ذكر الغزال) والظبي (هو ذكر أو أنثى الغزال) واليحمور (هو شبيه بالغزال ولونه يميل إلى الحُمرة وقرونه متشعبة) والوعل (هو تيس الجبال) والرئم (هو الثور الوحشي) والثيتل (هو البقر الوحشي) والمهاة (تُشبه الكبش وهي أكبر حجماً). وكل بهيمة من البهائم تشقُّ ظِلْفاً وتقسمه ظِلْفَيْن وتجترُّ، فإيَّاها تأكلون. إلاَّ هذه فلا تأكلوها مما يجترُّ ومما يشُقُّ الظلف المنقسم: الجمل والأرنب(2) والوبر (هو الأرنب البرِّي)، لأنها تجترُّ لكنها لا تشقُّ ظلفاً فهي نجسة لكم. والخنزير لأنه يشقُّ الظلف لكنه لا يجترُّ فهو نجس لكم. فمن لحمها لا تأكلوا، وجُثثها لا تلمسوا. وهذا تأكلونه من كل ما في المياه: كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه. لكن كل ما ليس له زعانف حرشف لا تأكلوه. إنه نجسٌ لكم. كل طير طاهر تأكلون. وهذا ما لا تأكلون منه: النسر والأنُوق (يُدعى كاسر العظام)(3) والعُقاب والحِدأة والباشق (من الطيور الكاسرة) والشاهين (من عائلة الصقور) على أجناسه، وكل غُراب على أجناسه، والنعامة والظُّليم (ذكر النعام) والسَّأَف (النورس) والباز على أجناسه (من عائلة الصقور)، والبوم والكُركي والبجع، والقوق (طائر مائي يأكل السمك) والرَّخَم (طائر جارح يُشبه النسر) والغوَّاص(4) واللَّقلق (من الطيور الجوارح، يأكل الضفادع والحشرات) والببغا على أجناسه، والهُدهُد والخُفَّاش(5). وكل دبيب الطير نجسٌ لكم، لا يؤكل. كل طير طاهر تأكلون» (14: 3-20).
والواقع أن قضية الطاهر والنجس قد حسمها الوحي الإلهي منذ البداية، حينما قرر عند خلق العالم أن كل ما عمله هو حسنٌ جداً (تك 1: 31). ولكن بعد أن أخطأ الإنسان وأَكَلَ من شجرة معرفة الخير والشر، وانفتحت عيناه واكتشف عُريه، لم يَعُد كل شيء طاهراً في عينيه، خاصةً بعد أن نطق الرب باللعنة على الحية من بين جميع البهائم ووحوش البرية، وعلى الأرض التي جبل الرب آدم منها، قائلاً: «ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكاً وحسكاً تُنبت لك وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أُخِذتَ منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود» (تك 3: 14، 17-19). فبعد أن كانت الخليقة كلها خاضعةً للإنسان ومن أجله خُلِقَت حتى أنه سلَّطه عليها، حينما قال بنُطقه الإلهي: «أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلَّطوا على سمك البحر وعلى طير السماء، وعلى كل حيوان يدبُّ على الأرض» (تك 1: 28)؛ إلاَّ أن الإنسان فَقَدَ سلطانه وسيطرته عليها بسبب الخطية التي ارتكبها متعدِّياً وصية الله بأَكْله من شجرة معرفة الخير والشر. فقد تغيَّرت نظرته لكل ما حوله، ولم يَعُد كل شيء طاهراً له، ولم تَعُد الأرض بما عليها طيِّعةً تحت يديه وخاضعةً لأمره. من هنا جاءت شريعة الطاهر والنجس التي أعطاها الله للإنسان كخطوة في طريق تقدُّمه نحو شريعة الكمال التي أتى بها رب المجد حينما تجسَّد وأعاد للإنسان نظرته الطاهرة للخليقة كلها، حينما قال لتلاميذه: «ليس ما يدخل الفم يُنجِّس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا يُنجِّس الإنسان» (مت 15: 11). وما أعلنه لبطرس الرسول في رؤيا، لما «رأى السماء مفتوحة، وإناءً نازلاً عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومُدلاَّة على الأرض. وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحَّافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قُم يا بطرس، اذبح وكُل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئاً دنساً أو نجساً. فصار إليه أيضاً صوت ثانية: ما طهَّره الله لا تُدنِّسه أنت!» (أع 10: 11-15)
ثم جاء بولس الرسول ليضع هذا المبدأ الروحي المبني على أساس ما أعلنه المسيح، بقوله: «إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجساً بذاته، إلاَّ مَن يحسب شيئاً نجساً، فله هو نجس» (رو 14: 14). مِن هذا المبدأ الروحي يتضح أن النجاسة ليست متعلِّقة بأي شيء من المخلوقات، لأنها قد خُلقت جميعاً طاهرة، بل هي مرتبطة بضمير مَن يتعامل مع هذه المخلوقات، فإذا حسبها نجسة فإنها تصير نجسة له وحده.
ولكننا الآن أمام شريعة إلهية أعطاها الله لبني إسرائيل بواسطة موسى النبي للتمييز بين الطاهر والنجس من الحيوانات والطيور والأسماك، فلابد أن لله قصداً في ذلك، لكي يُدرِّب ضمائرهم وحواسهم على التمييز بين الطاهر والنجس، والخير والشر، والحق والباطل، كخطوة في طريق الكمال والتحرُّر من نير الناموس: «إذاً قد كان الناموس مؤدِّبنا إلى المسيح، لكي نتبرَّر بالإيمان، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدِّب» (غل 3: 25،24). فقد وضع الله لهم تلك الشرائع والأحكام لتكون لهم عوناً وصوناً من التشبُّه بالأُمم الذين حولهم، «الذين إلههم بطنهم، ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات» (في 3: 19). أما بنو إسرائيل فكان الرب يُعدّهم ليكونوا له «مملكة كهنة وأُمة مقدسة» (خر 19: 6)، «لأنك شعب مُقدَّس للرب إلهك» (تث 14: 1).
وفي هذا يقول القديس كليمندس الإسكندري:
[يقول القديس بطرس في رسالته (الأولى) ما هو مُطابق تماماً لذلك: وإذ قد طهَّرتم أنفسكم في طاعة الحق، وإيمانكم ورجائكم اللذين هما في الله، «كأولاد الطاعة، لا تُشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضاً قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس»](6).
كما يقول أيضاً القديس إيسيذوروس السيفيلي (الذي من سيفيل بجنوب غرب أسبانيا):
[... ليس شيء ملوماً في ذاته من كل المخلوقات إلاَّ ذاك الذي صار هكذا بسبب الملامة التي حلَّت عليه من الخالق. ولكن هذا القانون قد أُعطِيَ لبني إسرائيل لكي يعود بهم إلى آداب الآباء البطاركة الذي فقدوه في مصر، حيث اعتنقوا عادات وعقائد أُمة وثنية. غير أنه بمجيء المسيح الذي هو غاية الناموس، فقد فتح ما كان مُغلقاً في الناموس، وكشف وأظهر ما كان مخفياً وغامضاً. فالمعلم العظيم، والحَبر السماوي، جعل الأمور التي كانت محتجبة بستارٍ من الظلال في القديم، ظاهرة منظورة بإعلانه الحقيقة... «كُلوا كل ما يُقدَّم لكم»! فكل المخلوقات استردَّت مكانتها وبركتها الأولى. ولكن انتبهوا، فإن كل شيء طاهر بما أنه من خليقة الله، إلاَّ ما تنجَّس بذبحه للأوثان: «فإذا قيل لك إن هذا قد ذُبح للأوثان، فلا تأكل منه» (انظر 1كو 8: 10)](7).
(يتبع)
**************************************************************************************************
بتصريح سابق من الأب متى المسكين بالإعلان عن مشروع معونة الأيتام والفقراء (مشروع الملاك ميخائيل)، حيث يعول دير القديس أنبا مقار منذ عام 2000 مئات العائلات المُعدمة، ويمكن تقديم التقدمات في رقم الحساب الآتي:
دير القديس أنبا مقار
بنك كريدي أجريكول مصر ــ فرع النيل هيلتون
*************************************************************************************************
(1) In Ioannen, 12,1. (Pusey 3,122,123).
(2) الأرنب: ليس من الحيوانات المجترة. ولم يكن الأرنب معروفاً في منطقة فلسطين في زمن كتابة العهد القديم. والمقصود به هنا بعض الحيوانات المجترة التي ربما تُشبه الأرنب المعروف لدينا اليوم. والكلمة اليونانية للأرنب هنا، كما جاءت في الترجمة السبعينية، هي: das?poda، ومعناها: حيوان ذو أقدام خشنة.
أما الأرنب المعروف اليوم فاسمه في اليونانية: lag?j.
The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, p. 616.
(3) الأنُوق: هذا الطائر يحمل الرمم والسلاحف في الهواء ثم يتركها لتسقط فتنكسر عظامها، ثم يأكل نخاع العظام، كما يأكل لحم السلاحف. وهو طائر بين النسر والعُقاب.
(4) الغوَّاص: هو طائر بحجم الغُراب، أسود اللون طويل المنقار، يطير عادةً فوق السواحل ليصطاد السمك (المرجع: ”مُعجم الألفاظ العسرة“).
(5) الخفاش أو الوطواط: ليس من الطيور، ولكنه من الثدييات واسعة الانتشار. وما يقصده سفر التثنية هنا، ليس تقسيماً بيولوجياً للتفرقة بين الطيور والحيوانات، لكنه تمييز بين الكائنات التي تطير عن الكائنات التي تمشي على أربع. لذلك يقول سفر التثنية: «والهُدهد والخُفَّاش، وكل حيوان له أجنحة يدبُّ على الأرض» (تث 14: 19،18 - حسب السبعينية).
(6) The Fathers of the Church, Vol. 85, Stromata, Book 3,110.
(7) PL 83,325,326,327.
ارجع أيضاً إلى كتاب: ”شرح سفر اللاويين“، لأحد رهبان دير القديس أنبا مقار، أصحاح 11، ص 83-93.