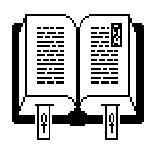|
ثالثاً: إعداد الجيل الجديد لميراث أرض الموعد (26: 1-36: 13) 2 - شرائع للتقدمات والنذور (28: 1-30: 16)
لم يقتصر الإعداد لميراث أرض الموعد على الإحصاء الذي أجراه موسى النبي للشعب من ابن عشرين سنة فصاعداً تنفيذاً لأمر الرب؛ بل تعدَّاه إلى توصية الرب لموسى بأن يُعيد على الشعب أوامره بخصوص الحرص على تقديم القرابين والذبائح للرب في وقتها المرسوم، لكي يكون لهم ارتباط دائم به ورائحة سرور يومية مرفوعة في حضرته كل صباح ومساء، هذا بخلاف التذكارات والأعياد الأسبوعية والشهرية والسنوية، التي تجعل حياتهم في عشرة مستمرة مع الرب الذي اختارهم له مملكة كهنة وأُمة مقدسة. لذلك بدأ الرب بتوصية موسى قائلاً: + «وكلَّم الربُّ موسى قائلاً: أَوْصِ بني إسرائيل وقُلْ لهم: قرباني، طعامي مع وقائدي، رائحة سروري، تحرصون أن تُقرِّبوه لي في وقته.» (عد 28: 2،1) أَمَرَ الربُّ موسى أن يوصي شعبه بأن يحرصوا على تقديم قرابينه في موعدها. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يوصي الرب فيها الشعب بهذا الخصوص، بل قد سبق وأوصاه بها مراراً. ففي اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الثانية لخروجهم من مصر أُقيم المسكن، وأُصعدت على المذبح المحرقة والتقدمة، كما أمر الرب موسى (انظر خر 40: 29،17). ثم أعطى الربُّ موسى شريعةَ الذبائح والقرابين بأنواعها (لا 1-7)، وكذلك ذبائح الأعياد والمواسم الشهرية والسنوية (لا 23). ولكن يبدو أن الجيل الذي كان على قيد الحياة، هم الذين كانوا أطفالاً عند الخروج من مصر، والذين وُلدوا فيما بعد خلال رحلة البرية؛ لذلك اقتضى الأمر أن يُعاد على أسماعهم كل ما أوصى به الرب سابقاً بشأن قرابينه التي يجب أن يحرصوا على تقديمها في أوقاتها، وبالأخص بمناسبة قرب دخولهم أرض الموعد، بل وتمهيداً وإعداداً لهذا الدخول المجيد، خاصةً وأن تنقُّلاتهم الكثيرة في البرية وترحالهم فيها طوال ما يقرب من أربعين عاماً لم يُمكِّنهم من المواظبة على الاحتفال المستمر بمواسمهم وأعيادهم، وتقديم القرابين الخاصة بكل مناسبة في حينها. أما ما يلفت النظر في توصية الرب لهم بالحرص على تقديم قرابينهم فهو قوله: «قرباني، طعامي مع وقائدي، رائحة سروري...». فهو ينسبها إلى نفسه باعتبارها تقدمات يتقبَّلها الرب بشوق ومسرَّة من يد الإنسان. ويشتمّها رائحة سرور؛ بل وينتظرها ويتوقَّعها كطعام، مع أن الله ليس في حاجة إلى طعام، إلاَّ أنه يحسبها شيئاً لازماً له كطعام، يتغذَّى عليه بالحب المُقدَّم فيه، ويبدو هذا المعنى أكثر وضوحاً في الترجمة السبعينية: «احرصوا أن تُقدِّموا لي في أعيادي، عطاياي، هداياي، محرقاتي، رائحة سروري». والواقع أن ما نقدِّمه للرب من عطايا إنما نقدِّمه مما له، متذكِّرين قول داود النبي والملك في صلاته التي بارك بها الرب قائلاً: «لك يا ربُّ العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض. لك يا ربُّ المُلْك وقد ارتفعتَ رأساً على الجميع... والآن، يا إلهنا نحمدك ونُسبِّح اسمك الجليل. ولكن مَن أنا، ومَن هو شعبي حتى نقدر أن نتبرع لك بأي شيء؟ نحن لا شيء. فكل شيء منك، ومما أعطيتنا أعطيناك.» (1أي 29: 11-14- الترجمة الجديدة) المحرقة اليومية الدائمة: + «وقُلْ لهم: هذا هو الوقود الذي تُقرِّبون للرب: خروفان حَوْليَّان صحيحان لكل يوم مُحرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحاً، والخروف الثاني تعمله بين العشاءين. وعُشْر الإيفة من دقيق ملتوت برُبع الهِين من زيت الرَّضِّ تقدمةً. محرقة دائمة، هي المعمولة في جبل سيناء، لرائحة سروري وقوداً للرب، وسكيبها رُبْع الهِين للخروف الواحد. في القُدْس اسكب سكيبَ مُسكرٍ للرب. والخروف الثاني تعمله بين العشاءين كتقدمة الصباح، وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب.» (عد 28: 3-8) بدأ الرب بتوصيتهم أن يُقرِّبوا له، أول ما يحرصوا على تقريبه هو المحرقة اليومية الدائمة، صباحاً ومساءً. أما كونها دائمة، فلأنها كانت تُقدَّم على المذبح «كل الليل حتى الصباح... والنار على المذبح تتَّقد عليه، لا تَطفأ... نار دائمة تتَّقد على المذبح لا تَطفأ» (لا 6: 13،12،9). وفي ذلك إشارة بليغة إلى ذبيحة المسيح الدائمة الأبدية، الذي «دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدياً» (عب 9: 12)، «الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يُقدِّم ذبائح: أولاً عن خطايا نفسه، ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرةً واحدة إذ قدَّم نفسه» (عب 7: 27). لذلك نُسبِّحه في التسبحة قائلين: ”هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا. فاشتمّه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة“ (ثيئوتوكية الأحد - القطعة الخامسة عشرة - كتاب الأبصلمودية المقدسة). هذه هي الذبيحة التي هي دائمة بالحقيقة، التي يصعد عبيق رائحتها، العطر المقدس، كل حين أمام الآب، رائحة سرور لا تتبدَّد ولا ينطفئ وقودها، ولا حاجة لتكرارها، مثل ذبائح العهد القديم التي كانت تُقدَّم كل يوم بسبب عجزها عن رفع خطايا مقدِّميها. إلاَّ أن المحرقة اليومية الدائمة قَصَدَ الرب بها رغبته أن يكون لنا ذِكْر دائم في قلوبنا لله، مُقدِّمين له العبادة الحارة بلا انقطاع ليل نهار، كما قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية: «فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله، أن تُقدِّموا أجسادكم ذبيحة حيَّة مقدسة مرضية لله عبادتكم العقلية.» (رو 12: 1) وفي هذا يقول العلاَّمة أوريجانوس: [ليس أحد يعطي شيئاً مما له لله؛ ولكن كل ما نُقدِّمه يخص الرب، ولا توجد تقدمة نُقدِّمها إلاَّ باعتبارها ردّاً للرب بما هو يخصّه. من أجل هذا فإن الرب حينما أراد إبلاغ الوصايا الخاصة بالذبائح والتقدمات التي ينبغي أن يُقدِّمها له البشر؛ بدأ بتعريفهم طبيعة هذه التقدمات جميعها بقوله: «هداياي، عطاياي، محرقاتي، رائحة سروري، احرصوا على تقديمها لي في أعيادي» (مترجمة من النص). هذه الهدايا - يقول الرب - التي آمركم بتقديمها لي في أعيادي، هي عطاياي، أعني أني أنا الذي أعطيتها لكم. فجنس البشر تقبَّل مني كل ما يملكه. فلا يتصوَّرن أحد، إذن، أنه قد زوَّد الله بشيء عند تقديمه لعطاياه! ولكن انظروا معنى ما يأتي: «هذا هو ما تُقدِّمونه لي في أعيادي». فهل الله، إذن، له أعياد؟ نعم، فإن له عيداً عظيماً هو عيد خلاص البشرية. فإني أظن أن لكل مؤمن، لكل الذين يتحوَّلون نحو الله ويتقدَّمون في الإيمان، تكون هناك فرصة عيد لهم عند الله... فإنَّ كل التحوُّلات التي تحدث للأشخاص (نحو الله) تُسبِّب فرحاً وتُنشئ عيداً لله. أما أول الأعياد التي لله، هو العيد الدائم (محرقة دائمة). فالله، في الواقع، يوصي أن يكون تقديم الذبائح دائماً وبلا انقطاع صباحاً ومساءً. وهكذا، في تشريع الأعياد هذا، لم يبدأ الرب بعيد الفصح ولا بعيد الفطير ولا بعيد المظال، ولا بأي أعياد أخرى، ولكنه جعل هذا العيد في مقدمة الأعياد، حيث تُقدَّم الذبيحة الدائمة بلا توقُّف... هذه هي الأعياد التي قال عنها الرب: «احرصوا أن تحفظوا أعيادي في أوقاتها» (مترجمة حسب النص). هناك، إذن، عيد للرب إذا نحن قدَّمنا له الذبيحة على الدوام، وإذا نحن «صلَّينا بلا انقطاع» (1تس 5: 17)، وإذا نحن ”أصعدنا (صلاتنا) بالنهار كالبخور قدَّامه، رافعين أيدينا أمامه كذبيحة مسائية“ (انظر مز 141: 2). هذا هو، إذن، الاحتفال الأول الذي هو تقديم الذبيحة الدائمة...](1) ويُذكِّر الرب بني إسرائيل بأن هذه المحرقة الدائمة ”هي المعمولة في جبل سيناء“، أي مثل تلك التي كانوا يعملونها في جبل سيناء بعد إقامة الخيمة في اليوم الأول في الشهر الأول من السنة الثانية لخروجهم من مصر (خر 40: 29،1). ويُفهم من هذا أن معظم الذبائح والقرابين قد توقَّفوا عن تقديمها أو تعذَّر تقديمهم لها بسبب رحلاتهم في البرية بعد مبارحتهم لسيناء. العيد الأسبوعي وتقدمات يوم السبت: + «وفي يوم السبت خروفان حوْليَّان صحيحان، وعُشران من دقيق ملتوت بزيت، تقدمةً مع سكيبه. محرقة كل سبت، فضلاً عن المحرقة الدائمة وسكيبها.» (عد 28: 10،9) مع المحرقة الدائمة التي تُقدَّم كل يوم نهاراً وليلاً، ما زال يوم السبت متميِّزاً بذبيحته الخاصة التي كانت تُقدَّم بالإضافة إلى الذبيحة الدائمة؛ ذلك لأن يوم السبت هو يوم الرب، وهو يوم الراحة الذي أوصى الرب بني إسرائيل بخصوصه في الوصايا العشر قائلاً: «اذكر يوم السبت لتُقدِّسه...» (خر 20: 8-11). وتقديس السبت هو تخصيصه وتكريسه للرب، فلا يُعمل فيه عمل سوى عبادة الرب، كقول إشعياء النبي بلسان الرب: «إن رددتَ عن السبت رِجْلك (توقفت عن العمل)، عن عمل مسرَّتك يومَ قُدْسي، ودعوتَ السبتَ لذةً، ومُقَدَّس الرب مُكرَّماً، وأكرمته (بالابتعاد) عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرَّتك والتكلُّم بكلامك، فإنك حينئذ تتلذَّذ بالرب...» (إش 58: 14،13). فهو راحة مقدسة في الرب في ختام أسبوع من العمل، ونياح وفداء من العبودية في نهاية أزمنة السخرة والمعاناة، وكلاهما يشيران إلى الراحة الأفضل التي هي آخر المطاف في السبت الأبدي بعد كمال العمل وكمال الفداء وكمال القداسة. وكما أكمل الله في اليوم السادس الخلقة الأولى ثم دخل إلى راحته؛ هكذا أكمل المسيح ابن الله في اليوم السادس فداء الخلقة الأولى وأعمال تجديدها بخلقة ثانية من فوق وصرخ قائلاً: «قد أُكْمِل» (يو 19: 30)، ثم دخل بنا إلى راحته، أي مجده الذي له. فكانت الراحة الأولى إشارة إلى الراحة الثانية التي نلناها بالنعمة بموت المسيح وقيامته، التي نعيشها الآن بالإيمان ونكمِّلها في السماء بملء الروح والكيان! وفي هذا يقول العلاَّمة أوريجانوس في تفسيره لسفر العدد: [العيد الثاني لهذه الأعياد، بعد الذبيحة الدائمة، هو الخاص بذبيحة السبت. فكل القديسين وكل الأبرار ينبغي عليهم أن يُعيِّدوا عيد السبت. ما هو، إذن، عيد السبت هذا إن لم يكن ما قال عنه الرسول: حِفظ السبت الذي كان يُراعيه شعب الله!... السبت الحقيقي، هو عندما يستريح الله من كل أعماله، الذي سوف يكون في الدهر الآتي، عندما يهرب الحزن والكآبة والتنهُّد، ويصير الله (المسيح) هو الكل في الكل (انظر كو 3: 11). حينذاك يمنحنا الله أيضاً في هذا السبت أن نصنع معه عيداً ونحتفل به مع الملائكة القديسين مُقدِّمين ذبائح التسبيح، ونوفي للعليّ نذورنا (انظر مز 50: 14)، ”التي نطقت بها شفاهنا“ (انظر مز 66: 14). وهكذا بلا شك يتم تقديم الذبيحة الدائمة على أفضل وجه، تلك التي تكلَّمنا عنها سابقاً، لأن النفس تستطيع حينئذ بلا أي جهد أن توجد بلا انقطاع في حضرة الله مُقدِّمةً له ذبيحة التسبيح بواسطة الكاهن الأعظم، الذي هو «كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق» (عب 5: 6).](2) الأعياد الشهرية: + «وفي رؤوس شهوركم تُقرِّبون مُحرقة للرب: ثورين ابني بقر، وكبشاً واحداً، وسبعة خراف حَوْليَّة صحيحة، وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزيت تقدمةً لكل ثور، وعُشْرَين من دقيق ملتوت بزيت تقدمةً للكبش الواحد، وعُشْراً واحداً من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل خروف، محرقةً رائحةَ سرورٍ وقوداً للرب. وسكائبهُنَّ تكون نصف الهِين للثور، وثلث الهِين للكبش، وربع الهِين للخروف من خمرٍ. هذه محرقةُ كلِّ شهرٍ من أَشْهُر السنة. وتيساً واحداً من المَعْز ذبيحة خطية للرب، فضلاً عن المحرقة الدائمة، يُقرَّب مع سكيبه.» (عد 28: 11-15) كانت رؤوس الشهور مواسم مقدسة عند بني إسرائيل حسب أمر الرب لهم، يُعيِّدون فيها أعياداً روحية دورية كل شهر، بالإضافة إلى احتفالهم اليومي بكل يوم واحتفالهم الأسبوعي بكل سبت. وهكذا جعل الله أيامهم معه كلها أعياد. فالحياة مع الله هي عيد دائم وأفراح مستمرة، كقول بولس الرسول: «افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضاً: افرحوا» (في 4: 4) (انظر أيضاً 2كو 13: 11؛ في 2: 18؛ 3: 1؛ 1تس 5: 16). حتى في آلامنا ينبغي أن نفرح كقول بطرس الرسول: «بل كما اشتركتم في آلام المسيح، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضاً مبتهجين» (1بط 4: 13). وكقول يعقوب الرسول أيضاً: «احسبوه كل فرح، يا إخوتي، حينما تقعون في تجارب متنوعة.» (يع 1: 2) أما بنو إسرائيل فقد كانوا يراقبون الهلال الجديد في أول كل شهر قمري، وعندما يرونه كانوا يعلنون عنه بإيقاد النار فوق الجبال والأماكن المرتفعة، كما أمرهم الرب بضرب الأبواق على الذبائح في رؤوس الشهور إعلاناً عنها واحتفالاً بها (عد 10: 10). ويُعلِّق العلاَّمة أوريجانوس على ذلك قائلاً: [الاحتفال الثالث في هذه الاحتفالات كان مُحدَّداً له يوم ظهور الهلال كل شهر، حيث تُقدَّم أيضاً ذبيحة... هذا الاحتفال، إذن، يختص بأحوال تغيُّر القمر. ويُقال إن القمر جديد عندما يقترب اقتراباً شديداً من الشمس، ويصير التحامه بها لصيقاً لدرجة أنه يختفي في ضياء نور الشمس. وهو يمكن أن يظهر بصورة مدهشة ويُرَى بمنظر مُبهر، حتى أن القانون الإلهي جعل من ذلك أمراً يجب متابعته. فما هي المنفعة في كون الشريعة تُحتِّم الاحتفال بعيد ظهور الهلال، أعني التحام القمر وارتباطه مع الشمس؟ إذا أعطينا التفاتاً حرفياً لهذه الظواهر الطبيعية، فإنها تبدو كأنها قائمة على خرافة أكثر من كونها عقيدة دينية. وبولس الرسول يعرف أن الناموس لا يتعامل مع هذه الأشياء، وأن هذا الطقس الذي يجب ملاحظته عند اليهود، لا يُطالب الروح القدس بجعله وصية يلزم اتِّباعها، لذلك قال لأولئك الذين قبلوا الإيمان بالله: «فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب، أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة» (كو 2: 17،16)... والحالة هذه، فإن المسيح هو شمس البر. فإذا كان القمر هو كنيسته المغمورة بنوره، فباتحادها به، إذا كانت ملتصقة به بكل قوة، فإنه يتحقق فيها تلك الكلمة التي قالها الرسول: «وأما مَن التصق بالرب فهو روح واحد» (1كو 6: 17)، مثل هذا يحتفل بعيد رأس الشهر (الهلال الجديد)، لأنه صار جديداً، إذ قد خلع الإنسان العتيق ولَبـِسَ الإنسان الجديد المخلوق حسب الله (انظر أف 4: 24).](3) (يتبع) (1) Hom. sur les Nombres, S.C. III; Hom. XXIII,2,1,3,1. (2) Ibid., Hom. XXIII,4.3. (3) Ibid., Hom. XXIII,5.1,2. |